واضعو خطة الطوارئ الوطنية يقولون إن هدفهم «حماية اللبنانيين واللبنانيات من تداعيات عدوان إسرائيلي واسع، وتأمين مستلزماتهم وإغاثتهم في حالة حصول تهجير قسري واسع من ديارهم إلى أماكن أكثر أماناً في لبنان. ولتحصيل هذه الغاية، تهدف الخطة ومندرجاتها إلى تعزيز جهوزية القطاعات ذات الصلة لحالة طوارئ متعددة الجوانب». وتفترض الخطة أنه سيتم تجهيز مليون لبناني، وأن هناك حاجة لمراكز إيواء جماعية تستوعب 20% من النازحين (المهجّرين)، بالإضافة إلى ضغط على القطاع الصحي، والحاجة إلى تأمين المستلزمات الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء، وأنه سيكون هناك حصار بري وبحري... وتسترسل الخطة في عملية التنظيم من خلال «وضع إطار تنسيقي مع منظمات الأمم المتحدة لتطبيق الخطة والاستجابة...»، وتحدّد الجهة المعنية بتنسيق إدارة الخطة بـ«اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات». وبالطبع، حدّدت الخطة الاحتياجات ونطاق عمل كل وزارة. لكن ما لم تقله هو كيف ستتم إدارة الموارد، بدءاً بالتمويل ثم التخزين والتوزيع والبيع؟ عملياً، تُرك الأمر بيد القطاع الخاص الذي تعهد بأن يعزّز جهوده لتعزيز المخزون من سلع غذائية ومحروقات وأدوية وسواها، إذ لم تذكر الخطّة أي شيء عن إدارة المخزون وعن الأسعار ودورها في حماية المستهلك من الاحتكار والتلاعب بالسلع وفي مدى توافرها.
المشكلة الفعلية هي أن «عقل» السلطة قائم على محو الذاكرة. ففي كل الحروب التي مرّت على لبنان، والأزمات التي رافقتها، وحتى في حالات الكوارث والطوارئ، لم يكن هناك أي وجود للسلطة - كقناة بين شرعية الدولية ومواطنيها - موازٍ لحضور زعماء الطوائف وأحزابهم وممثليهم. وعلاقات هؤلاء مع الخارج كانت هي مصدر التمويل الأساسي لأي عملية إغاثة، وهذا ثابت بعد عدوان 2006، وبعد الانهيار النقدي والمصرفي في 2019، وانفجار المرفأ في 2020... ففي هذه المراحل، شهد لبنان انقطاعاً للسلع الأساسية وتفنّن القطاع الخاص في التلاعب بتوافرها وبتسعيرها وبيعها، أما أعمال الإغاثة فكانت على عاتق مموّلين خارجيين لديهم صلات مع جهات محليّة. الأمر واضح للعيان، إذ لم تنشأ وحدة إدارة الكوارث في لبنان إلا في 2010، أي بعد نحو عشرين عاماً على انتهاء الحرب الأهلية، وبعد حروب إسرائيلية مدمّرة حوصر فيها لبنان برّاً وبحراً وجوّاً ومارست فيها الصهيونية جرائم الإبادة بالجملة. هذه الخلفية لم تظهر في مهام الوحدة المنشأة لدى الحكومة، بل طُلب منها أن تعدّ استراتيجية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث، وخططاً تنفيذية وتحديثها، ومعايير لقياس التقدّم فيها، وتنسيق الدراسات، وتعميم «النداء الإنساني»... ولم تمنح الهيئة أي صلاحيات بناءً على تشريعات تتيح لها اتخاذ أي قرار وفرضه في حالات الطوارئ.
لم تذكر خطّة الحكومة شيئاً عن إدارة المخزون وحماية المستهلك من الاحتكار والتلاعب بالأسعار
ثمة تجارب مقابلة لدول لديها حروب كبيرة مع الكيان الإسرائيلي مثل مصر قبل توقيع اتفاقات سلام وتطبيع مع العدو، وتجارب لدول أخرى لم تختبر الحروب والكوارث، إنما لديها علاقات مع العدو. بمجملها تفرض هذه الدول إدارة المخزون الاحتياطي ووضع اليد عليه في حالات الضرورة ومراقبة التسعير والبيع وتوافر السلع. في مصر مثلاً، ثمة نشرة رسمية تصدرها وزارة الاقتصاد عن المخزون الاستراتيجي ويرد فيها أن هناك 28 سلعة يجب توافرها بشكل استراتيجي (قمح، زيت خام، دواجن، لحوم حية ومجمدة، فول، سكر...)، وقرّرت مصر في 2021 أن تشيد 7 مستودعات ضخمة لهذه السلع بهدف «الإنتاج والتوزيع والتخزين ومنع التلاعب». أما في قطر، فقد صدر المرسوم 24 في عام 2019 الذي يرخّص للشركات المسموح لها تكوين مخزون استراتيجي ويحظّر إقفال المنشآت أو وقف استيراد هذه السلع من دون علمها، كما يحذّر من منع عرض السلع أو احتكار تداولها أو إخفائها ورفع أسعارها أو إرغام المستهلك على شراء كمية منها أو فرض شراء سلعة أخرى. ومنحت قطر للوزير المختص صلاحية توجيه الموردين لشراء كميات من سلع محدّدة وتخزينها لدى الدولة، وأعطت «الإدارة المختصّة» حق التصرّف بهذه السلع في حالات الطوارئ من خلال «استلام المخازن وإدارتها والتصرف بالكميات فيها» مع حفظ حقوق ذوي الشأن بتعويض عادل. والأمر مماثل في الإمارات العربية التي أقرّت في 2020 قانوناً اتحادياً رقم 3 «بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع» وفيه تحدّد «مخزون الأمان» ومن يحق له التصرّف فيه وحقوق الموردين والمنتجين وكيفية إدارة هذا المخزون وصلاحية وضع اليد عليه والتصرّف فيه وحصرت كل ذلك بـ«هيئة إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية».
عملياً، قطر والإمارات ليس لديهما تاريخ من الحروب أو الأزمات، وهما تمارسان درجات متوحشة من الرأسمالية بأبعادها المختلفة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، وقد قرّرتا حصر إدارة الموراد أثناء الكوارث والأزمات بيد السلطة العليا.
في المقابل، جرى تأطير هذه العملية في لبنان ضمن الأطر نفسها التي سُجن المجتمع فيها لعقود، أي الطائفية والزبائنية وتمجيد القطاع الخاص. كما أن السلطة تتغافل أيضاً عن وجود مرسوم اشتراعي صادر في عام 1967 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ التي تنجم عن «خطر مداهم ناتج من حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو أعمال أو اضطرابات تهدّد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة»، وعندها يتاح للسلطة العسكرية العليا «فرض الأكلاف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل: الأشخاص والحيوانات والأشياء والممتلكات». هذا التشريع استعمل أيام «كورونا» لفرض منع التجوّل، إلا أن ذكره لم يرد بعد رغم أن لبنان في حالة حرب نشطة على حدوده الجنوبية. ورغم كل الانتقادات التي يمكن توجيهها لمرسوم تصبح فيه القوى العسكرية العليا مديراً لكل الموارد، إلا أنه يعدّ أداة ولو كانت «متخلّفة» نسبياً عما هو في مصر وقطر والإمارات. لبنان في قلب الحرب، لكن السلطة في وادٍ آخر. هي مفلسة وواقعة تحت هيمنة مجموعة من التجّار والمحتكرين الباحثين عن الأرباح حصراً. تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للحكومة، وخصخصة بالكامل للقطاع الخاص وإن كان هناك إدارة شبه حكومية تشرف على ذلك.

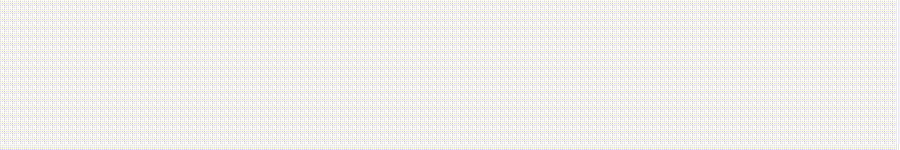

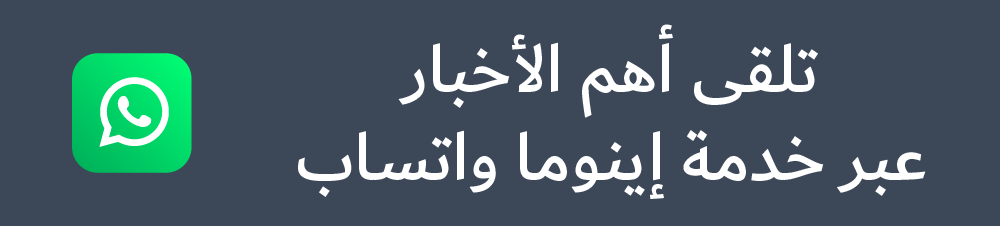








.png)