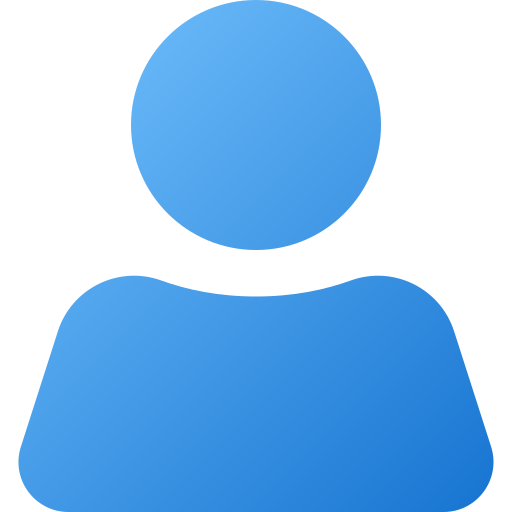بعد اجتياح القوات الإسرائيلية لجنين في العام 2000 وارتكابها جرائم ضد الإنسانية، وبعد تقديم الرئيس بوش الابن لرئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق شامير في البيت الأبيض بصفته "رجل سلام"، أبرق الملك عبدالله إلى الرئيس الأميركي برسالة غاضبة، سلّمها له سفيره، الأمير بندر بن سلطان، ملخّصها، أنه تأتي أيام يفترق فيها الأصدقاء ويذهب كلٌّ في طريق.
مواقف تاريخية
غيّرت القيادة الأميركية من مسارها، وأعلنت تأييدها الحق الفلسطيني في دولته المستقلّة. ثم جاءت "غزوة" مانهاتن، التي خطّطت لها إيران، ونفّذتها القاعدة على يد تسعة عشر إرهابياً، منهم خمسة عشر سعودياً منشقّاً، حرصوا على حمل جوازاتهم السعودية، فأفسدوا كلّ شيء.
لم يكن التهديد السعودي للبيت الأبيض، والغرب عموماً، الأوّل من نوعه، فقد سبقه موقف الملك سعود بعد العدوان الثلاثي على مصر في 1956، وغضبة الملك فيصل بعد الجسر الجويّ لإسرائيل في حرب رمضان 1973؛ وفي الحالتين استخدمت الرياض سلاح النفط لمعاقبة الدول المؤيّدة لتل أبيب.
طلبات أميركا
وأخيراً، وفق ما تروي تقارير أميركية وبريطانية متواترة، استمع الأمير محمد بن سلمان لطلبات الرئيس جو بايدن خلال زيارته العام الماضي، وحضوره قمة الأمن والتنمية في جدة، برفع إنتاج النفط، وطرد روسيا من منظمة أوبك، ومنعها من المرور عبر الأجواء السعودية، والمشاركة في حملة العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضدها رداً على غزوها لأوكرانيا، والانضمام إلى مسيرة التطبيع مع إسرائيل واتفاقيات إبراهيم، وتخفيض التعاون مع الصين.
سأل الأمير عن المقابل لكلّ هذه التنازلات والتضحيات، فردّ بايدن بأنها ضريبة الصداقة، ومقابل زيارة سيدفع ثمنها سياسياً وانتخابياً، إن لم يعد بحقيبة إنجازات، ومقابل إيقاف الحملة السياسية ضد المملكة، ومنع المحاكم الأميركية من قبول قضايا تمسّ ولي العهد.
طلبات السعودية
ردّ الأمير بأن الصداقة طريق من مسارين، وعلاقة نديّة بين طرفين، وليست لمصلحة طرف على حساب آخر، وتُبنى على التعاون والثقة لا على التهديد والمساومة؛ وأن العلاقات بين الدول تقوم على تبادل المصالح وتشارك المنافع. فكما أنكم تسعون لخدمة مصالح بلادكم، ويحاسبكم شعبكم على التقصير فيها، فنحن أيضاً نعمل على تعظيم المنفعة، ويُحاسبنا شعبنا على التفريط.
فوجئ رئيس الدولة العظمى بهذا الرّد الذي لم يألفه من زعامات أخرى، واستوضح عن ماهية المطالب السعودية، فعدّدها الأمير، وكانت تشمل توفير ضمانات أمنية كاملة، ودعم البرنامج النووي السلميّ، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم محلياً، بإشراف وكالة الطاقة الذرية، وتزويد المملكة بما تحتاجه من السلاح النوعيّ بالمستوى المقدّم لإسرائيل، والمساهمة الجديّة في إنهاء أزمة اليمن، والتزام إسرائيل بقبول قيام دولة فلسطينيّة عاصمتها القدس، بحسب المبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن.
رفض برفض
تململ الرئيس الأميركي، وتعذّر بأن تلبية المطالب "الصعبة" تحتاج إلى موافقة "صعبة" من الكونغرس وإسرائيل، وأن الأمر قد يطول، وهو بحاجة إلى العودة إلى الناخب الأميركي بإنجاز؛ وليكن تخفيض أسعار الطاقة بزيادة الإنتاج السعودي، والضغط على أعضاء "أوبك +" للقيام بذلك، على الأقلّ لمدة شهرين، حتى تنتهي انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني.
جاء الرد السعوديّ حازماً بالرفض، ومعلّلاً بأن قرارات "أوبك +" مبنية على دراسات معمّقة لسوق الطاقة، وأن زيادة غير مدروسة للإنتاج ستُربك الأسواق، وتضرّ بالمستهلك والمنتج (بما في ذلك الأميركي)، وأن تخفيض الإنتاج سيحافظ على الاستقرار، ولن يؤدي إلى زيادة الأسعار بالشكل الذي تنبأت به الدراسات الأميركية، وأن مشكلة أميركا داخليّة، تتعلّق بمنظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين والضرائب والسياسات البيئيّة، وليس لها علاقة مباشرة بالإنتاج الدوليّ للنفط.
مواجهة "النفط"
عاد الرئيس الاميركي محبطاً، وليس في حقيبة إنجازاته إلا السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية التجارية في أجواء السعودية، من دون الهبوط في مطاراتها. وهدأت الاعتراضات على الموقف النفطيّ السعوديّ عندما أثبتت الأيام صحّته، إذ انخفض سعر البرميل عن معدّلاته العالية، واستقرّت الأسواق العالمية، التي لم تستعِد بعد صحّتها بعد أزمة كورونا، ولم يتأثر الناخب الأميركيّ نتيجة لذلك، ولقرارات أميركية تتعلّق بالصرف من المخزون النفطيّ.
تكرّرت الأزمة مرة أخرى عندما قرّرت السعودية ورفاقها في أوبك مواصلة سياسة تخفيض الإنتاج لتصحيح مسار هبوط الأسعار، وأصرّت على القيام بتخفيضات طوعيّة لإنتاجها. فهدّد البيت الأبيض علناً بتطبيق عقوبات قاسية على أوبك، ومراجعة شاملة للعلاقات مع السعودية، قد تشمل اتفاقات تجارية وعسكرية وأمنية.
الحزم السعودي
جاء ردّ الرياض صارماً، وإن لم يكن معلناً، بإيقاف كلّ المصالح والمعاملات مع الولايات المتحدة، ويشمل ذلك المشتريات الحكومية والخاصة، وربط مبيعات النفط بالدولار، وسحب الأرصدة المالية الموجودة في أميركا، وبيع الأصول والسندات الحكومية دفعة واحدة، والانتقال بالاستثمارات والمعاملات والصفقات السعودية إلى دول منافسة.
تراجعت أميركا على الفور عن تهديداتها، وهدأت فجأة كلّ الحملات الدبلوماسية والإعلامية على المملكة، وأبلغت المحاكم الأميركية بعدم استقبال أيّ دعاوى قضائيّة ضد ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، حسب القانون الذي يمنع مقاضاة شخصيات اعتبارية وسيادية أجنبية، وتوافدت القيادات والوفود السياسية والعسكرية على الرياض وجدّة، تعرض حلولاً للأزمة القائمة.
العرض الأميركي الجديد
عادت واشنطن إلى طرح "المقترحات" بعد إعادة صياغتها واستبعاد المرفوض تماماً منها، وركّزت في المرحلة الحالية على تدعيم العلاقات الأمنية وعودة الحضور العسكري إلى الخليج والبحر الأحمر لتأمين الممرات البحرية، وتوجيه رسالة حازمة إلى كلّ من يفكّر في الاعتداء. وفي المقابل، على السعودية الالتزام بعدم منح الصين أو روسيا قواعد أو تسهيلات جوية وبحرية، وتخفيض التعاون العسكري معهما، والتعهد بعدم التخلّي عن الدولار كعملة تعامل وبعدم فكّ ارتباطه بالريال السعوديّ أو برميل النفط، وتخفيض مستوى التعاون مع إيران وحلفائها.
ويرى البيت الأبيض أن الوقت قد حان لتشكيل تحالف إقليمي أمني واستخباراتي وعسكري لسدّ أيّ ثغرات قد تتسلّل منها الصين وروسيا وإيران، وسوق تجاريّة وتنمويّة واستثماريّة في المنطقة تشمل إسرائيل، مقابل إحياء المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، والإسرائيلية - العربية، على مبدأ حلّ الدولتين؛ وأن يبدأ الأمران معاً، وفي وقت واحد. وستدعم واشنطن وترعى هذا الحراك، وتسهم بعلاقتها المتميزة مع إسرائيل في تيسير ودعم هذا الاتجاه. وفي المقابل، يتولّى شركاؤها العرب دفع الفلسطينيين بنفس الاتجاه.
الرّد السعودي الثابت
الرّد السعودي طرح المطالب السابقة كما هي، مؤكّداً أنّ القبول الإسرائيلي المسبق بالمبادرة العربية كأساس للتفاوض، والتوقف عن أيّ سياسات، وتجميد أيّ إجراءات تغيّر الوضع الراهن، أو تستفزّ الطرف الفلسطيني، تأتي أولاً، وقبل أيّ خطوات تطبيع. كما يأتي القبول الأميركي بالمطالب السعودية للضمانات الأمنية، ومبيعات السلاح المتقدّم، ودعم البرنامج السلمي النووي، بشرط التخصيب المحليّ، ومشاريع الرؤية السعودية للسلام والمصالحة، للتنمية والأمن في المنطقة.
عاد الأميركيون بهذه المطالب لتدارسها مع المشرّعين والمؤسّسات المعنية وتل أبيب، وتوقّفت مسيرة الاتفاق عند هذه المحطة بانتظار الرّد. وعلى مسار آخر، استمرّت خطوات الرياض للتطبيع مع طهران، والتعاون الاستراتيجي مع بيجينغ وموسكو، ودعم القضية الفلسطينية، بتعيين أول سفير سعودي في رام الله، وقنصل عام في القدس الشرقية. كما تمضي التخفيضات النفطية على الخطّ الذي رسم لها، ويمضي التعاون مع أعضاء "أوبك +" لضبط إيقاع سوق الطاقة بما يُحقق مصالحهم واستقرار السوق النفطية، من دون التأثّر بالضغوط والسياسات الأميركيّة والغربيّة.
الحياد و"خذ وهات"
قد يطمع الأميركيون في تحوّل جذريّ للسياسة السعودية، وقد يحصلون على بعض ما يأملون. لكنّهم سيضطرون هم أيضاً إلى تحوّلات جذريّة في أسلوب تعاملهم ليكون مبنيّاً على مبدأ "خذ وهات"، كما أن التغيّر السعودي لن يشمل التنازل عن مبدأ الحياد الإيجابي في الصراعات الدولية. فالمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية تقتضي توازناً مدروساً بين الشركاء؛ والشراكات تبنى على الثقة والالتزام والوفاء. وبالتالي، لن تنقلب الرياض على أيّ شريك، أو تتنصّل من أيّ اتّفاق، أو تُضحّي بأيّ مصلحة.
يبدو أنّ الرسالة وصلت "أخيرا"!