
28-10-2019
مقالات مختارة
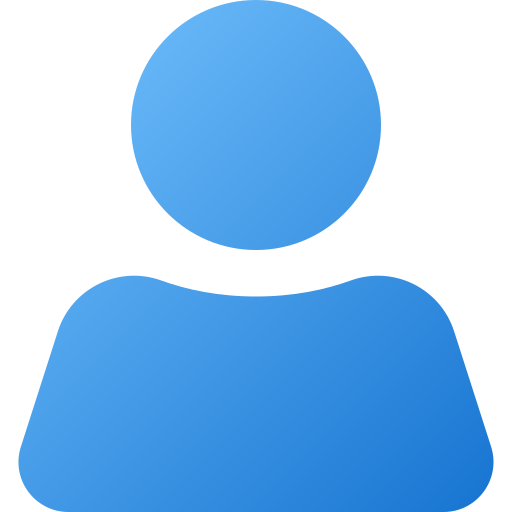
حسن خليل
كاتب سياسي واقتصادي
ثورة حضاريّة، بات واضحاً أنّ الكثير من العواصف تتربّص بها، نجحت حتى الآن في تحقيق الكثير، قياساً بعمرها الفتي: إرباك السلطة التي تتقلص خياراتها يوماً بعد يوم، وفي الوقت نفسه تثبيت قواعد اللعبة، ونقصد سلميّة التحرك، وملء الساحات، وتقطيع أوصال الطرق.
أمّا وقد بلغت الأمور ما وصلت إليه، فما هي الخيارات المتاحة أمامنا، ولو نظريّاً، خصوصاً أنّ السلطة قد رمت الكرة في ملعبنا، بعرض للحوار لتحقيق المطالب؟ التراجع ومغادرة الساحات خيانة بكل المعايير، وليس هناك من هو في وارد مجرد التفكير في خيار كهذا. والرهان على استقالات أهل الحكم والتسليم التلقائي ضرب من ضروب الخيال.
عليه، نكون أمام ثلاثة احتمالات لا رابع لها:
1) الحفاظ على الوضع القائم، بمعنى البقاء في الساحات ومواصلة قطع الطرق ورفض الحوار. أشبه بلعبة شدّ أصابع، الخاسر فيها من يصرخ أولاً. خيار دونه مجموعة من المخاطر، لعل أولها موجة استياء شعبي تقلب تعاطف الرأي العام المُحايد ضدنا، بفعل نجاحنا في شلّ الحياة في البلد. لكنّ أسوأها استعجال الانهيار المالي، فنكون كمَن يدمّر المعبد على من فيه، هذا إن لم يحمّلنا الرأي العام مسؤوليته، خصوصاً مع عدم وجود إشارات حتى اليوم، لا من الخليج ولا من العالم الغربي، إلى استعداد لمساعدات عاجلة للبنان لإخراجه من عنق الزجاجة المالي. والحديث عن الانهيار المالي ليس ترفاً فكريّاً، بل حقيقة باتت واقعاً قائماً، بدليل عجز المصارف عن فتح أبوابها، وتسارع تهريب الرساميل إلى الخارج. وحتى لو أدى ذلك، في نهاية الأمر، إلى استقالة السلطات الثلاث، رئاسة وحكومة وبرلمان، فإنّ السلطة الانتقالية، التي ستتولى المسؤولية باسم الثورة، ستتسلم جثة هامدة لا روح فيها، وشعباً يعاني المجاعة، ومجتمعاً بلا موارد تعصف به الفوضى.
2) الارتقاء في التصعيد إلى مستوى جديد، كأن تبدأ الثورة بتضييق الخناق على أهل الحكم إلى حدّ إحكام الطوق. خطوة من هذا النوع ستؤدي حكماً إلى استشراس الطرف الآخر في الدفاع عن وجوده وكينونته، وبالتالي نصبح أمام شارع في مقابل شارع. مسار لا بد أن يفقد الثورة أهم ميزاتها «السلميّة»، ما يفتح الباب أمام احتمال من اثنين: إمّا الاصطدام بالمؤسسة العسكرية والأمنية في حال قررت الوقوف إلى جانب السلطة، وبالتالي قد يتكرر سيناريو عام 1976، فتنقسم المؤسسة وتدخل البلاد في مرحلة اقتتال داخلي. أو تقف على الحياد، فيدخل لبنان في فوضى مسلّحة، تفاقم من عنفها تداعيات الانهيار المالي، أحد لا يستطيع أن يتوقع كيف ستنتهي. المأساة، إذا ما حصل ذلك، لا سمح الله، أنّ معظم الضحايا سيكونون من المدنيين الأبرياء، وليس ممّن ركبوا الثورة أو تغلغلوا فيها أو استغلوها.
3) إستثمار الإنجازات الحالية لتحقيق هدفين في آن: إنتزاع الحقوق وحفظ البلد، وذلك عن طريق تَلقّف المبادرة الرئاسية باعتبارها مدخلاً يمكن البناء عليه، وفق نظرية «التفاوض تحت النار». والمقصود أن تدخل الثورة مرحلة جديدة تقوم على مسارين متوازيين: الضغط في الشارع والحوار في القصر، على أن يتم التحكّم بالمسار الأول، تصعيداً وتهدئة، بحسب مجريات المسار الثاني. من ميزات خيار كهذا، أنه يحيّد «الشارع الثاني»، ويخفف من حدة التشنّج في البلاد، وفي الوقت نفسه يستمهل الانهيار، ويعطي بارقة أمل يمكن أن تشجّع المجتمع الدولي، على الأقل الجزء المعني منه باستقرار لبنان، على تثبيت وضعه، ولو مؤقتاً. لكنها أيضاً خطوة دونها مخاطر، الأبرز فيها قدرة الثورة على التوحّد على قلب واحد، والتفاهم على تصعيد قيادة تمثلها تحظى بثقة الشارع وقادرة على إدارة الأزمة، وتمثيل الثوار بأمانة. من لوازمها، نضج في السياسة، وزهد في الشخصانيّة، وتعقّل في المقاربة، وحكمة في التعامل، وخبرة في المبازرة، وثبات في المواقف، والتزام في القضايا، ومناعة ضد المغريات.
كثر من ساسة لبنان أعمَتهم شهوة السلطة، استخفوا بالثورة، فنجحت في تحجيمهم من أكبرهم إلى أصغرهم. وهناك من بين الثوار من استخف، ولا يزال، بنظرية المؤامرة، وما فتئ متمسكاً بالنقاء الثوري. كلهما على خطأ. الثورة قائمة وحيّة وستنجز. وكذلك المؤامرة، موجودة وحيّة وتجهد لتدنيس الثورة.
الأمل، كل الأمل، في أن يتمكن ثوار لبنان من أن يهتدوا إلى الخيار الصحيح، وتحقيق ليس فقط النجاح في أول ثورة من نوعها يشهدها هذا البلد، بل استثماره لئلّا يتحول انتحاراً جماعياً.

أبرز الأخبار